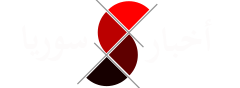سكاي نيوز عربية - 11/19/2025 9:54:13 AM - GMT (+2 )

فالصراع، منذ اندلاع مواجهاته الواسعة، تحوّل إلى معادلة معقدة تتداخل فيها الأبعاد العسكرية والسياسية والمجتمعية، ما يجعل الوصول إلى تسوية نهائية أمراً بالغ الصعوبة.
تضارب الروايات حول الشرارة الأولى
يؤكد الجيش أن الأزمة بدأت بتحركات “مريبة” لقوات الدعم السريع في محيط مطار مروي وداخل العاصمة، في مخالفة — بحسب وصفه — لاتفاقات الانتشار. ويشير إلى أن قواته تعاملت مع هذه التحركات باعتبارها تهديدا مباشرا.
في المقابل، تقول قوات الدعم السريع إن وجودها في المواقع المشار إليها تم بموجب تفاهمات مسبقة، وإن الجيش هو من بدأ الهجوم المسلح.
الرواية الثالثة: اتهامات للحركة الإسلامية
يضيف خالد عمر، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني وقيادي بتحالف صمود، رواية ثالثة تتهم عناصر من الحركة الإسلامية — التي حكمت السودان حتى عام 2019 — بالعمل على إشعال الحرب لاستعادة النفوذ السياسي ومنع الانتقال المدني.
وبينما تنفي قيادة الجيش أي صلة سياسية لقراراتها، تتهم قوى الحرية والتغيير بمحاولة تصوير الجيش كطرف مناهض للتحول المدني.
بيئة انفجار قابلة للاشتعال
اندلعت المواجهات في منطقة حضرية مكتظة بالسكان، وفي سياق أمني هش يضم انتشارا واسعا للسلاح. كما أن الطرفين يملكان امتدادات جغرافية واسعة؛ الجيش في الشرق والدعم السريع في الغرب.
وتزامن ذلك مع انهيار الخدمات الأساسية وتراجع مؤسسات الدولة، ما جعل الصراع يتوسع بسرعة.
يرى الكاتب و الباحث السياسي السوداني فايز السليك خلال حديثه لـ"التاسعة" على سكاي نيوز عربية أن الحرب لم تبدأ بإطلاق النار، بل سبقتها حالة تعبئة سياسية وأمنية.
ويعتبر أن الحركة الإسلامية عملت منذ سقوط نظام البشير على خلق بيئة مناسبة للمواجهة، مستشهدا بتصريحات قيادات بارزة داخلها — منها حديث علي عثمان محمد طه عن "كتائب الظل" — بوصفها مؤشرا مبكرا على استعدادات مسبقة لأي صراع.
كما يشير إلى حوادث إطلاق النار على المتظاهرين خلال فترة الاعتصام أمام القيادة العامة، معتبراً أنها جزء من مسار طويل يقود نحو المواجهة.
ويشدد السليك على أن احتمال اندلاع الحرب كان قائما قبل أبريل بكثير، ولا سيما خلال يونيو 2021، حين حدثت مشادات حادة بين الفريقين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو. ويؤكد أن تدخل حكومة عبدالله حمدوك وقيادات قوى التغيير أحبط حينها تفجر الصراع.
كما يشير إلى أن كوادر الحركة الإسلامية أعلنت مرارا رفضها إكمال الانتقال السياسي وتمرير الاتفاق الإطاري، الذي كان يهدف إلى بناء جيش قومي موحّد ودمج قوات الدعم السريع.
15 أبريل.. يوم الرصاصة الأولى
بحسب السليك، فإن الشرارة الفعلية وقعت في المدينة الرياضية بالخرطوم، حين حوصرت قوة من الدعم السريع داخل الموقع بواسطة قوات أخرى قدمت من خارجه، قبل أن يبدأ إطلاق النار.
ويرى أن عناصر من الحركة الإسلامية لعبت دورا أساسيا في هذه اللحظة، بينما لم يكن قادة الجيش أنفسهم على علم دقيق بتوقيت بدء الاشتباك.
ويضيف أن بعض الأطراف كانت ترغب في فرض الحرب "رغماً عن إرادة القادة العسكريين"، بهدف إعادة تشكيل موازين القوة ومنع الوصول إلى سلطة مدنية.
ويلفت السليك إلى أن المدنيين لم يمكنوا من معرفة مستوى التوترات قبيل اندلاع الحرب، ما حال دون تشكيل ضغط شعبي أو احتجاجات سلمية كان يمكن أن تساهم في احتواء الأزمة.
ويقول إن المعلومات المتعلقة باحتمال التصعيد كانت محصورة في نطاق ضيق، وإن انكشافها لاحقاً أظهر حجم القصور في الشفافية.
حرب متعددة الطبقات
يؤكد السليك أن الحرب الحالية ليست مجرد مواجهة بين قوتين، بل صراع مركب يضم:
• انقسامات مجتمعية وإثنية.
• أجندات سياسية متنافسة.
• ارتباطات إقليمية..
• اقتصاديات حرب.
• توسّع عسكرة المجتمع.
ويحذر من أن الحرب تحولت بالنسبة لبعض الفئات إلى مصدر دخل وثقافة معيشية، الأمر الذي يزيد صعوبة إنهائها.
إمكانات إنهاء الحرب.. وواقع التعقيدات
من الناحية النظرية، يمتلك قادة الجيش والدعم السريع القرار العسكري لوقف إطلاق النار. لكنّ تعدد القوى المتداخلة، وتآكل مؤسسات الدولة، وارتفاع حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية، كلها عوامل تجعل قرار الإنهاء أكثر تعقيداً من قرار البدء.
ويعتبر السليك أن السودان يمكن أن يخرج من الحرب إلى مسار دولة مستقرة وقوية إذا أغلقت دورة النزاعات، على غرار تجارب دول شهدت حروبا أهلية طويلة. إلا أن ذلك يبقى مرهونا بقدرة الأطراف على تجاوز الحسابات الضيقة.
ويرفض السليك الطرح القائل إن ثورة ديسمبر أدت إلى الحرب، مؤكداً أن الصراعات المسلحة في السودان ممتدة منذ عام 1955، وأن أسباب الحرب الحالية تتعلق بتعطيل مصالح قوى مرتبطة بالنظام السابق.
ويشدد على أن الثورة واجهت منظومة مهيمنة لا ترغب في التخلي عن السيطرة على الدولة ومؤسساتها.
إقرأ المزيد